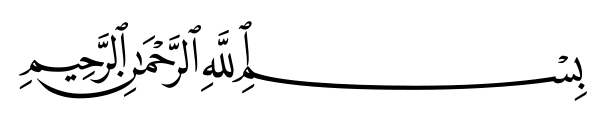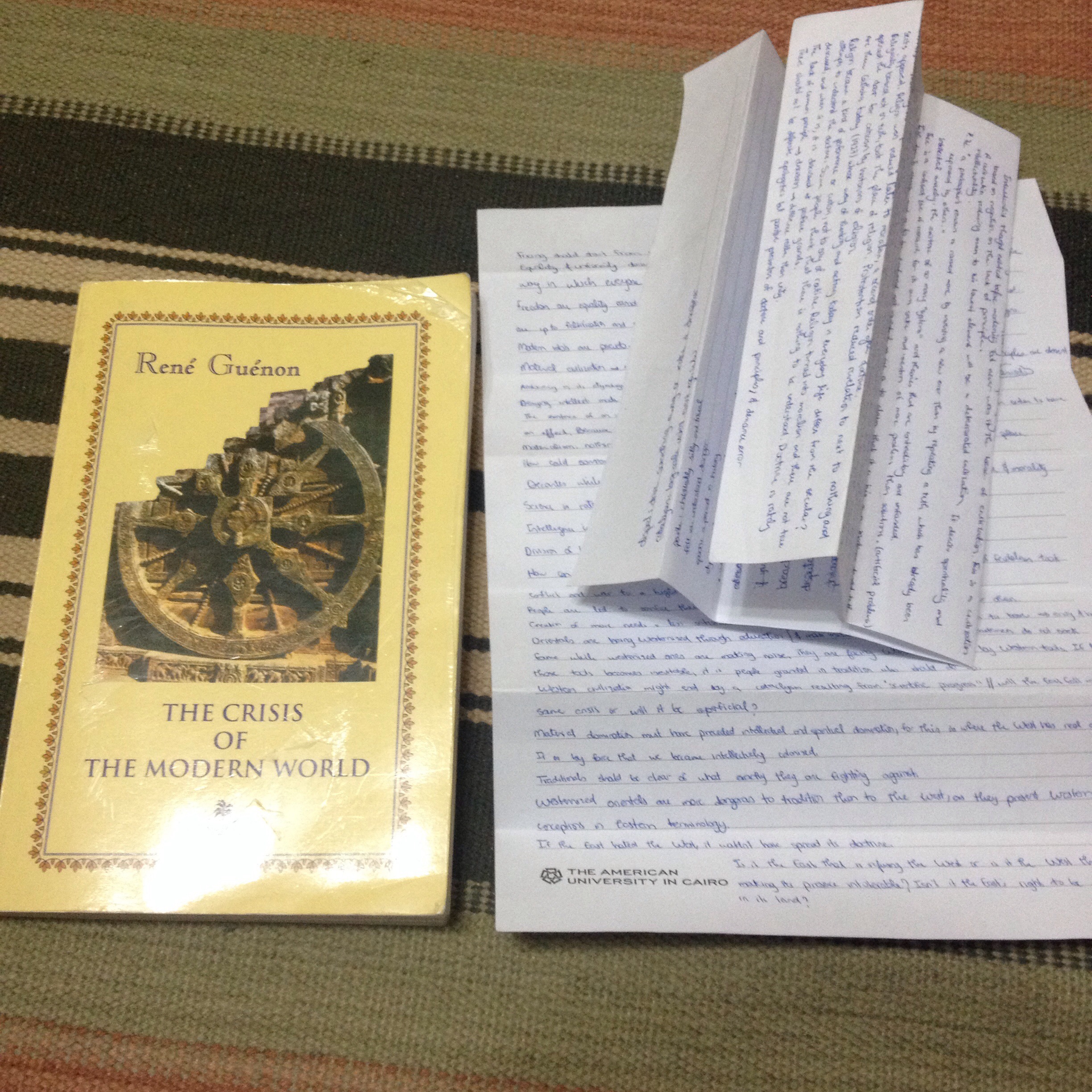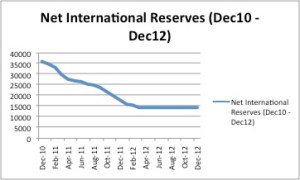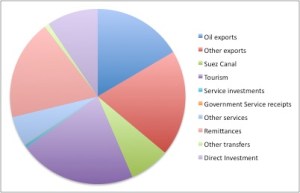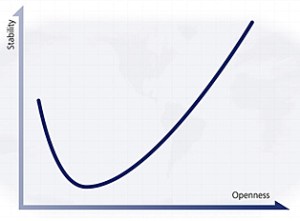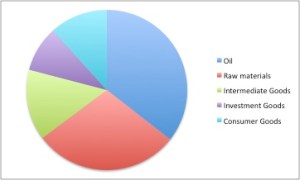كيف نفهم ما نراه في الكون على أنه شر؟
كتبت هذه التدوينة عام ٢٠١٧ ونشرت لأول مرة على موقع مدونة سؤال
ألقيت ذات يوم محاضرة تحت عنوان: “هل الفلسفة حرام؟ مقتطفات من تاريخ الفلسفة في العالم الإسلامي.” في فقرة الأسئلة، سرعان ما انتقل النقاش من أسئلة في صلب الموضوع إلى السؤال عن ما يسمى بمعضلة الشر. السؤال الأول الذي تلقيته كان عن رأي علم الكلام في هذا الموضوع، والثاني كان عن رأيي الشخصي فيه.
كانت الإجابة عن السؤال الأول هي الأسهل. ذكرت فيها رأي الفلاسفة الإسلاميين وهو أن الشر أمر عدمي وليس وجوديا فلا يكون الإله مسؤولا عنه، ثم رأي المتكلمين وهو إلزام السائل بوجود الله والقول بأن الخالق من العدم لا يُسأل عما يفعل، وقول الصوفية بأن الإله له حكمة من ذلك وإن كانت خفية.
ثم جاء ردي على السؤال الثاني بأن رأيي مماثل لرأي المتكلمين، فأنا أؤمن بالإله الذي لا يجوِّز العقل عدم وجوده، وأن هذا هو الخيار العقلاني. ثم أضفت أنه لا يلزم من عدم رضانا عن الواقع أن هذا الواقع غير موجود، فالإنسان الذي يصاب بمرض لا يفيده إنكار وجود المرض. المرض موجود وهذا شيء مؤلم، وإنكار الواقع لا يغير من حقيقته. كذلك عدم رضا شخص ما بفعل من الأفعال الإلهية لا يجعل الإله غير موجود.
الحقيقة أن هذا الجواب لا يشفي الغليل، فهو كأنه يقول للمستمع: هذه هي الحقيقة شئت أم أبيت وعليك أن تقبل بها وتسكت الصوت الذي بداخلك لأنه مخالف للعقل! ويترك الجوابُ المستمعَ في تحيُّره ورغبته في أن يعرف السر وراء هذا الاختيار الإلهي الذي يبدو مؤلما أو -استغفر الله- عبثيا. وهذا المعنى قد أشار إليه الإمام صدر الدين القونوي في رسالة أرسلها للفيلسوف نصير الدين الطوسي ليوضح له أن طريقة الصوفية هي التي تؤدي إلى فهم حقائق وأسرار الكون وليس الاستدلال العقلي.
ولعل المشكلة التي تكمن في الاكتفاء بالاستدلال العقلي هي كون هذا الاكتفاء يجعل الخطاب اختزاليا. فهو يتعامل كأن العقل هو الآلة المدركة الوحيدة في الإنسان، والحقيقة بخلاف ذلك. فالإنسان له كذلك النفس، والقلب، والروح، والسر.
فالنفس تدرك الشهوة والغضب، والغرض منها أن تستقيم حياة الإنسان بأن تدفعه إلى جذب المنافع ودفع الأضرار. والعقل ينسب المسبَّبات إلى أسبابها، وبه يستطيع الإنسان أن يفهم الكون من حوله ويتعامل معه. والقلب هو الجسر بين عالم الشهادة الذي نعيش فيه وعالم الغيب الذي هو أوسع من هذا العالم. فمتى أدرك الإنسان بعقله أن له خالق وأن مقتضى رسالة الرسول أن يتوجه بقلبه تجاه هذا الخالق، كان القلب هو آلة التوجه وتكون ثمرة هذا التوجه أن يقترب الإنسان من عالم الغيب وتبدأ روحه في إدراك هذا العالم وأسراره إلى أن تتحقق له معرفة الله التي هي الغاية من وجوده والتي هي اللذة التي ما بعدها لذة.
حينئذ يفهم الإنسان الحكمة من أفعال الله، ويصير الغيب عنده شهادة، ويدرك يقينا أن لكل فعل من أفعال الحكمة وأنه كما قال الإمام الغزالي: ليس في الإمكان أبدع مما كان!
كذلك يرى الأشياء على حقيقتها، فيعرف أن كل موجود هو تجل لاسم من أسماء الله. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم ليدل عليه {سنريهم آياتنا في الآفاق} فيكون كل موجود ما هو إلا لافتة تشير إلى أصلها. فهذا المخلوق يدل على اسم الله الباسط وذلك على اسمه البديع وذاك على اسمه القهار. فيكون ما يعبر عنه الإنسان بالشر هو تجل لاسم الله المانع أو القهار أو الجبار أو غيرها من الأسماء. ولعل هذا ما يشير إليه قول أحد العلماء: من كان أعرف بأقسام المخلوقات وحقائقها كان أعلم بأسمائه تعالى.
ولسائل أن يسأل: لماذا لا يخفي الله هذه الأسماء ولا يظهرها فلا تكون هذه المعاناة المشاهَدة؟
الجواب لهذا السؤال أن الله أراد للإنسان المعرفة الكاملة. قال تعالى {وعلم آدم الأسماء كلها} وكان سياق هذا القول بيان الله تعالى لسر تفضيل سيدنا آدم على الملائكة واستخلافه في الأرض، إذ أنه أعلم من الملائكة بالله وبأسمائه. فالملك وإن كان لا يعصي الله أبدا، فإنه لنفس هذا السبب لا تكون معرفته بالله كاملة إذ أنه لا يعرف اسم الله التواب لأنه لا يعصي فلا يلجأ لله بصفته توابا. ومن هذا يُفهم أن العبد كلما تعرف على الله بأسماء أكثر زادت معرفته بالله التي فيها كماله وكمال سعادته في الآخرة التي هي حياة أبدية. ويكون كل ما يواجهه المرء من الصعوبات على وجه الحقيقة خيرًا للإنسان وسببًا لسعادته إن فهم أن هذه الصعوبات هي أحبال للتعارف يمدها الله للعبد، وسارع إلى التمسك بهذه الأحبال وتسلُّقِها.
هذه المعاني إن فهمت تحولت إلى مصدر سعادة للإنسان، وكانت سببا لزيادة تشوقه للمعرفة التي تفوق لذتها كل اللذات الحسية. ذلك لأن اللذة الحسية ما هي إلا إزالة لألم، وسرعان ما تنقضي هذه اللذة بعد أن يأخذ الإنسان كفايته منها. أما المعرفة فلا تزيد صاحبها إلا تشَوُّفًا للمزيد منها ويظل الإنسان باحثا عنها مهما استمرت حياته.
اللهم أذقنا لذة معرفتك واسلك بنا سبيل أحبابك من غير فتنة.